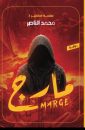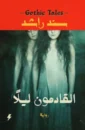الغنوصية، أو العرفانية، هي تيار فكري وديني باطني نشأ في أواخر القرن الأول الميلادي، ويقوم على فكرة أن المعرفة الروحية الداخلية هي السبيل الوحيد للخلاص. هذه المعرفة لا تُكتسب من خلال التعليم أو الطقوس الظاهرة، بل من خلال الاستنارة الشخصية التي تكشف للإنسان حقيقته الإلهية ومصدره السماوي. يرى الغنوصيون أن العالم المادي شرير أو ناقص، وقد خُلق بواسطة كائن أدنى يُعرف باسم “الديمورجوس”، وهو ليس الإله الأعلى الحقيقي، بل مجرد صانع للعالم المادي الذي يُعتبر سجنًا للروح.
في قلب الغنوصية تكمن فكرة أن الإنسان يحمل شرارة إلهية داخل جسده، وهذه الشرارة تسعى للتحرر والعودة إلى عالم النور، أو “البليروما”، الذي يمثل الكمال الإلهي. لذلك، فإن الغنوصية تميز بين الإله الأعلى الخفي الكامل، وبين الإله الأدنى الذي خلق المادة. هذا التمييز ينعكس في نظرتهم إلى يسوع، حيث يُعتبر في النصوص الغنوصية كائنًا إلهيًا جاء ليكشف للبشر المعرفة السرية، وليس ليؤسس ديانة جماعية أو يقدم خلاصًا عبر الصلب.
تأثرت الغنوصية بعدة تيارات دينية وفلسفية، منها اليهودية غير الحاخامية، والمسيحية المبكرة، والأفلاطونية، والزرادشتية، والبوذية. وقد ظهرت نصوصها في مخطوطات نجع حمادي التي اكتُشفت في مصر عام 1945، وتضمنت أناجيل غنوصية مثل إنجيل توما، وإنجيل يهوذا، وسفر يوحنا السري، وهي نصوص تركز على المعرفة الداخلية وتنتقد التصورات التقليدية عن الإله والخلاص.
رغم أن الكنيسة الأرثوذكسية اعتبرت الغنوصيين مهرطقين، إلا أن تأثيرهم استمر في الفكر الباطني والروحانيات الحديثة، وظهر في تيارات مثل الثيوصوفيا، والقبّالاه، وبعض أشكال التصوف. كما أن الغنوصية أثرت في الأدب والفن، حيث تُستخدم رموزها في أعمال تتناول الهوية والوعي والقدر.

المقارنة بين الغنوصية والتصوف الإسلامي تكشف عن نقاط تقاطع مذهلة رغم اختلاف السياقات التاريخية والدينية، فكلاهما يسعى إلى تجاوز ظاهر الدين نحو عمقٍ روحي يكشف جوهر الحقيقة الإلهية.
في الغنوصية، المعرفة هي مفتاح الخلاص، لكنها ليست معرفة عقلية، بل كشف داخلي يُحرر الروح من سجن الجسد ويعيدها إلى مصدرها السماوي. كذلك التصوف الإسلامي يرى أن الطريق إلى الله ليس في الظواهر والطقوس فقط، بل في التجربة الباطنية والتطهير الداخلي الذي يُوصل الإنسان إلى المعرفة العرفانية (المعرفة بالله). فكما يعتقد الغنوصيون أن الإنسان يحمل شرارة إلهية، يرى المتصوفة أن الإنسان يحمل روحًا نفخها الله فيه، وهي القادرة على الاتصال بالمطلق.
كلا التيارين يستخدمان الرموز، والأساطير، واللغة الشعرية للتعبير عن مفاهيم روحية قد يصعب إدراكها بالعقل وحده. في الغنوصية هناك البليروما وممالك النور، وفي التصوف هناك الحضرات الإلهية ومقامات السالكين. حتى فكرة “الموت قبل الموت” التي نجدها عند الغنوصيين كتحرر للروح، نجد لها صدى في التصوف الإسلامي عبر مفاهيم الفناء والبقاء: أن يفنى الإنسان عن نفسه ليبقى بالله.
ومع ذلك، يبقى الفرق جوهريًا في النظرة إلى العالم والمادة. الغنوصية تتبنى موقفًا ثنائيًا يعتبر العالم المادي شرًا يجب التحرر منه، بينما التصوف الإسلامي لا يشيطن المادة بل يرى فيها تجليات الإله، ويعتبر الكون مرآة تعكس صفات الله، ولهذا فإن السلوك الروحي في التصوف لا يعني رفض العالم بل تطهير النظر إليه.

في الغنوصية، تمر الروح بمراحل استنارة تدريجية تهدف إلى التحرر من الجهل والعودة إلى الأصل الإلهي. هذه المراحل تشبه إلى حد كبير مقامات التصوف الإسلامي، حيث يسلك المريد طريقًا روحيًا يتدرج فيه من الظاهر إلى الباطن، ومن الجسد إلى الروح، ومن النفس إلى الحق.
في التصوف الإسلامي، تبدأ الرحلة بـالتوبة، ثم الورع، والزهد، والفقر، والصبر، والرضا، والتوكل، وصولًا إلى المعرفة والمحبة والفناء في الله. كل مقام يتطلب مجاهدة ومراقبة للنفس، ولا ينتقل السالك إلى مقام أعلى إلا بعد استيفاء شروط المقام السابق.
أما في الغنوصية، فالرحلة تبدأ بـالوعي بالانفصال عن الأصل الإلهي، ثم السعي نحو المعرفة الباطنية (غنوسيس)، يليها التحرر من المادة، والاستنارة الداخلية، ثم الاتحاد مع النور الإلهي. هذه المراحل لا تُكتسب بالمجهود فقط، بل تُمنح أيضًا كهبة من الإله الأعلى، وتُعتبر تجربة باطنية تتجاوز العقل والمنطق.
التشابه بين النظامين
- كلاهما يرى أن العالم المادي حجاب يجب تجاوزه.
- المعرفة الحقيقية لا تُدرك بالحواس، بل بالقلب أو الروح.
- الهدف النهائي هو العودة إلى الأصل الإلهي أو الاتحاد به.
الاختلافات الجوهرية
- الغنوصية تميل إلى الثنائية الحادة بين الخير والشر، الروح والمادة، بينما التصوف يرى أن المادة ليست شرًا بذاتها بل وسيلة للترقي.
- التصوف الإسلامي يربط الرحلة الروحية بالشريعة والعبادات، بينما الغنوصية تتجاوز الطقوس الظاهرة نحو التجربة الباطنية فقط.

الغنوصية والتصوف الإسلامي يشتركان في كونهما طريقين روحيين يسعيان إلى تجاوز الظاهر نحو جوهر الحقيقة الإلهية. كلاهما يعتبر المعرفة الداخلية شرطًا للخلاص، ويتعاملان مع العالم كحجاب يجب اختراقه للوصول إلى النور.
لكن بينما تميز الغنوصية بين عالمين متضادين — عالم الشر والمادة مقابل عالم النور والروح — وتعتبر أن الخلاص يتحقق بالتحرر من الجسد، يرى التصوف الإسلامي أن المادة ليست عدوًا، بل وسيلة لفهم الله وتجلياته، وأن الخلاص يتم عبر تهذيب النفس والسير في مقامات روحية تنتهي بالفناء في الله.
النتيجة؟ كلا المسارين يهدفان إلى الارتقاء، لكن الغنوصية تتبع رؤية ثنائية صارمة، والتصوف ينسج رؤيته من داخل الإيمان الإسلامي ليصنع توازنًا بين الظاهر والباطن، الجسد والروح، العقل والمحبة.


 by عبدالله قاسم
by عبدالله قاسم